ما زلت أتذكر البدايات الأولى من طفولتي ما أن يسدل الليل أستاره أنطلق إلى جدتي في خيمتها الهندية التي تشبه المثلث زيتية اللون، ما زلت أتذكر حنانها وعطفها الواسع الذي لا نهاية له في حياتها، أنا طفل صغير ولكني في عينيها كبير، كنت أحضا برعاية فائقة منها- رحمها الله – فكانت لي مصباح شديد الإضاءة في عتمة الليل البهيم، رغم طفولتي وما يحتويها من شغب الأطفال إلا أنها لا ترى مني إلا حلمها المستقبلي اليافع.
كوني آنذاك الابن الأكبر لأبي فأنا مدلّل ومحاط برعاية كبيرة من الأبوين إلا أنني أميل إلى جدتي فهي تمتلك (كاريزما) خاصة ونادرة اتجاهي، لذلك ما أن أجد فرصة انطلق إلى خيمتها الرحبة، وأيضاً آنذاك أنا الحفيد الوحيد والقريب من الأجداد.
ما زلت أتذكر قصصها التي تحكي لي بها قبل النوم حتى أخلد له بسلام، القصص كلها رعباً تطرد النوم عن الجفون ولكن هذا ما اكتسبته من الأزمنة الغابرة فهدفها نبيل وإن كان مرعباً، كانت تسرد القصص متتالية وكلما زادت من سرد القصص كلما ابتعد النوم عني أكثر.
كنا قاطني جانب الوادي المهيب أحد أودية (مشاحيد نجد) نسيت اسمه وكانت خيمة جدتي تبعد عن بيت والديّ حفظهما الله بمسافة حسب تقديري أنها لا تزيد عن الثلاثين متراً، ذات ليلة ربيعية ممطرة تميل إلى البرودة انطلقت مسرعاً إلى خيمة جدتي- رحمها الله – بعد أن أطبق علينا الليل بظلمته القاتمة، وكان سبب انطلاقي قوة الرعد وضوء البرق الذي يحيل الكون إلى منتصف النهار، دخلت الخيمة وأنا بسرعتي القصوى فالتصقت بجدتي على حين غفلة منها فتفاجأت ما بك يا (أبوي) فقلت(خوّفني) البرق والرعد والليل فاحتضنتني وهدأت من روعي.
اشتدت الرياح وبدأت تضرب جوانب الخيمة حتى إني خفت أن تقتلعها الرياح وبدأ المطر ينهمر بغزارة وجدتي ما بين تسبيح وتهليل وذكر لله لا يتوقف، وهي ما بين فرح بالمطر وخوفاً من حدوث مكروه للخيمة، كان الباب مفتوحاً من الأسفل وأشاهد وميض البرق الشديد فيكشف لنا الوادي المهيب وطبيعته الربيعية الخضراء ويزيدها جمالاً البرق اللامع، وكشف لنا البرق مسارب المياه مع مجاريها باتجاه الوادي فخرير المياه العذبة الجارية ما زال صداها في أذني منذ (43) عاماً يا له من منظرٍ مهيب!!
أدركت جدتي خوفي من سوء الأحوال الجوية فقالت سأحكي لك (حجّيوة) تعني قصة فهزيت رأسي إيذاناً بالموافقة، فسردت عليّ من(سوالف) حجرف الذويبي وقصته مع الخروف والجني وقصة (سيسبانة وليلبانة والسعلوّة) وكلها قصص خرافية متوهمة أنها تجلب النوم لي، وكلما أكثرت من سرد القصص المرعبة على مسامعيّ ابتعد النوم عني أكثر.
توقّف المطر وهدأت الرياح وتهافت إلى مسامعنا خرير المياه الجارية المنحدرة باتجاه الوادي يا له من نغم تطرب له النفوس، فخرجت جدتي وتحمل بيدها (الفانوس) القديم الذي يعمل بوقود(الكاز) تتفقد أطراف الخيمة الخارجية والحواجز الترابية التي تمنع اقتراب السيل من أطراف الخيمة، وتستطلع مجاري المياه وعذوبة ألحانها وأيضاً تستمتع بالطبيعة الخلابة بعد تشبّعها من مياه الأمطار يا لها من مناظر ربانية مهيبة.
في بادئ الأمر لا تريد جدتي أن أخرج معها خوفاً عليّ من البرد والبلل ولكنها وافقت مكرهةً لإصراري على الخروج معها خوفاً من الظلام داخل الخيمة، امشي خلف جدتي ولا أرى إلا ما يصل إليه ضوء (الفانوس)، وما عدى ذلك ظلام دامس فتجاوزت نظراتي الضوء ودَخَلَت الظلام الدامس، فأصبح كل شيء أمامي أسوداً قاتماً فتخيّلت الوحش(السِعر) يشق الظلام باتجاهي فتملّكني الذعر وبدأت اقترب من جدتي فلاحظت الشيء ذلك فقالت:(خلّك) رجل مثل الرجال.
صقل الشجاعة في مسامعي من قبل جدتي فشل فشلاً ذريعاً، فقد غلبت تلك المهارات التي تريدها جدتي القصص الخرافية المرعبة التي تُصقل في أذنيّ كل ليلة قبل النوم، حاولت أن أتحلّى بتلك الصفات التي تريدها جدتي ولكن الرعب ضرب بأوتاره مخيّلتي وجميع مفاصل جسمي، وأصبحت نظراتي لا تفارق خيال الوحش المرعب وهو يتقدم باتجاهي ببطء متبختراً يا له من منظرٍ مخيف، عدنا إلى الخيمة ومرّ الكثير من الوقت فقالت جدتي: أين الوحش الذي أرعبك؟ وأجابت هي على الفور ألم أقل لك أنه لا يوجد وحش!!
كنا آنذاك لا نعرف السهر فغلبني النوم رغم أنفي واستسلمت له، ولم أفيق إلا على ثغاء صغار الأغنام بعد شروق الشمس، فخرجت من الخيمة فإذا بالأرض قد ارتوت وأصبحت أكثر اخضراراً فهي عبارةً عن واحة غنّاء زاهية تسر ناظريها يا له من جمال ربّاني عظيم.
رحلت جدتي(نمشة بنت عوض) – رحمها الله – وبقيت سيرتها العطرة متوهجةً في ذاكرتي وذاكرة كل من يعرفها، كانت قريبة من قلوب الجميع صغاراً وكباراً، القريب والبعيد، ذكوراً أم إناثاً.
يقال إن أهل نجد أكثر البشر توجّداً على ديارهم عبر التاريخ، كانت نجد إذا رزقها الله بأمطار تمتاز بمزايا فريدة لا يعرفها إلا من عاش فترة الثمانينات والسبعينات الميلادية وما قبلها عبر التاريخ.






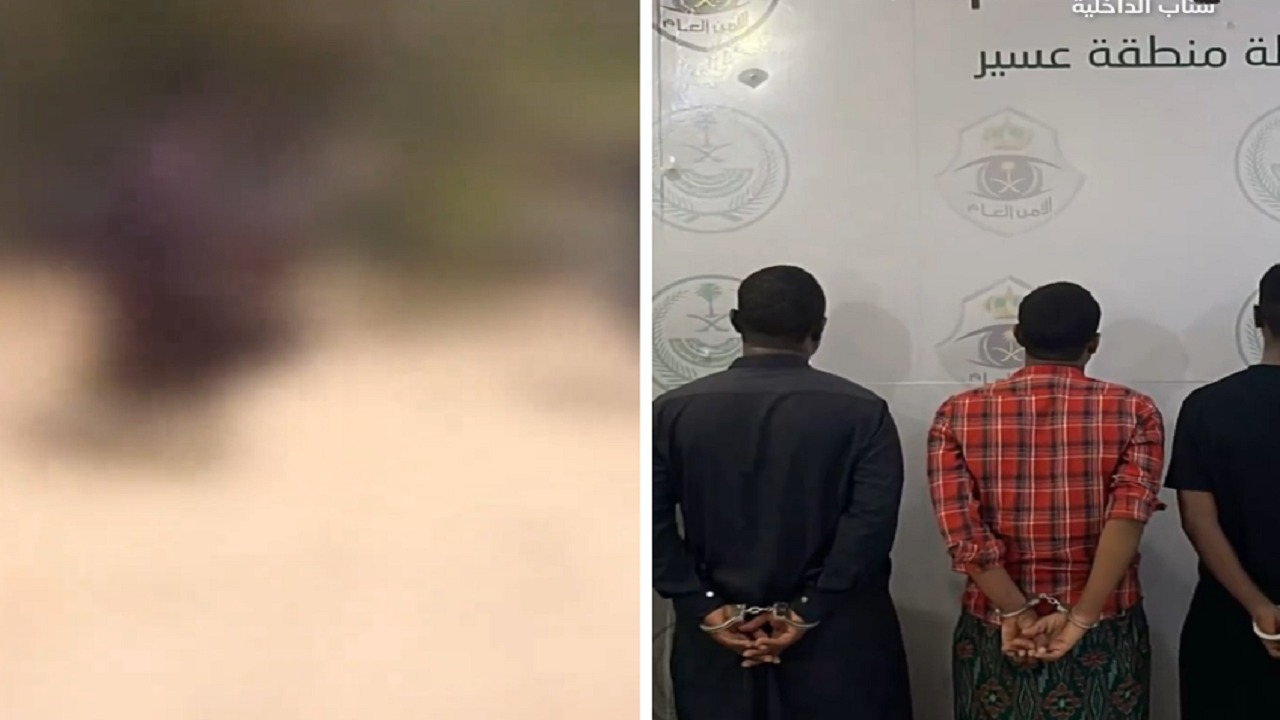
التعليقات
اترك تعليقاً